فهم الدين بين الرجل والمرأة: قراءة في المقدّس
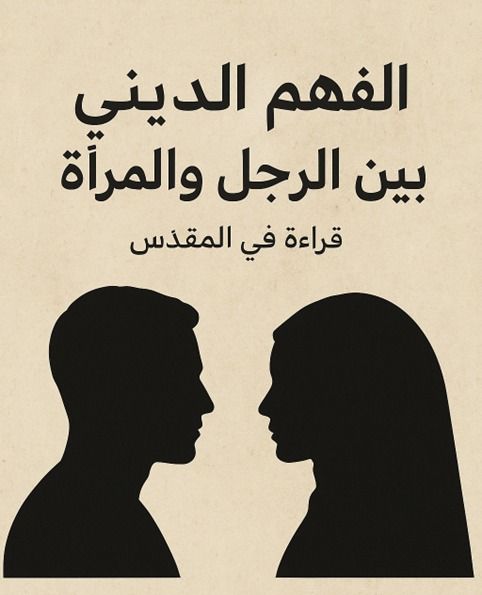
فهم الدين بين الرجل والمرأة: قراءة في المقدّس
د. مهند العلام 14.10.2025
يقدّم هذا المقال قراءة فلسفية اجتماعية في الفروق بين الرجل والمرأة في إدراك وفهم الدين، بوصفها نتاجًا للبنية الاجتماعية والثقافية لا للاختلاف البيولوجي، ومن خلال تحليل العلاقة بين السلطة والمعنى في التجربة الدينية، يسعى المقال إلى فهم ضرورة تفسير الرجال للمقدّس وإبراز الأبعاد الإنسانية الكامنة فيه، في محاولةٍ لاستعادة التوازن بين العقل والعاطفة، وبين النصّ والتجربة.
لعل من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في تاريخنا الديني والإنساني مسألةُ الفروق في فهم الدين بين الرجل والمرأة، والقضية ليست اختلافًا في جوهر الحقيقة الدينية فهي واحدة، بل في طرائق الوصول إليها، تتحدد بعوامل عدة مرتبطة بعلم الاجتماع الديني والفلسفة والدراسات الجندرية، اذ يُنتج اختلاف الجندر أنماطًا متباينة من الوعي الديني نابعة من التكوين الاجتماعي لا من الطبيعة البيولوجية في بيان تأثير البنية الأبوية على إنتاج المعرفة الدينية.
وكثيرا ما نواجه أسئلة كمثل، لماذا هيمن الرجال على كتابة النصوص الدينية وتشريعها وتفسيرها؟ وهل يعني هذا أنّ الرجال احتكروا الإيمان، ام أنهم احتكروا سلطة تأويله وتمثيله المؤسسي؟ وما معنى المرأة ناقصة عقل ودين؟
والإجابة ليست بسيطة أو أحادية الجانب، بل هي نتيجة لتفاعل معقد من العوامل التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وسينطلق هذا المقال من المنظور الاجتماعي الفلسفي لتحليل الفهم الديني بوصفه نتاجًا للعلاقات الاجتماعية وتمثّلات السلطة الثقافية..
في السياق التاريخي والاجتماعي كانت المجتمعات البشرية لآلاف السنين مجتمعات أبوية، وكانت بنية الأدوار الاجتماعية محددة للرجل في المجال العام كالحرب والسياسة والتجارة، بينما حدد للمرأة المجال الخاص كرعاية المنزل وتربية الأطفال.
وعادة ما كانت كتابة التاريخ والتشريع الديني محصورة على من يسيطر على المجال العام، أي على من يسيطر على وسائل إنتاج المعرفة وأدواتها كالكتابة ومستلزماتها والمؤسسات التعليمية محكومة بهذه البنية، فكانت الكتابة والتشريع والفتوى امتدادًا لهيمنة اجتماعية وسياسية سابقة، لا لحقيقة دينية جوهرية.
وفي ظل هيمنة النظام الأبوي تاريخيًا لم يُسمَح للنساء بكتابة الدين ليس لأنهن غير قادرات، بل لأن النظام الاجتماعي كان يستبعدهن من هذه المواقع، او لان تجاربهن الدينية الروحية والغنية العميقة خاصة، لا تكتب، ولم تُوثَّق، لأنها لم تكن تُمارس ضمن مؤسسات السلطة الدينية ولانّ أدوات التدوين والمعرفة لم تكن متاحة لمن يعيش خارج النظام الأبوي.
اما بالنسبة الى تفسير النصوص وتأويلها فهيمنة تفسير الرجال فيها واضحا حتى عندما تكون النصوص الأصلية تحتوي على بذور مساواة أو تقدير للمرأة، فإن عملية التفسير والتأويل التي استمرت لقرون كانت بأيدي الرجال.
ولا شك أن المفسرين تأثروا بسياقاتهم، وقرأوا النصوص من خلال عدسة واقعهم الاجتماعي وافتراضاتهم الثقافية، ففسّروا الآيات أو النصوص التي تبدو مساوية للمرأة بطريقة تتناسب مع الأعراف الأبوية السائدة، وتم تجاهل النماذج الأنثوية حين تم التركيز على الرجال كالأنبياء والملوك والابطال مقابل تهميش النماذج النسائية كالعالمات والصالحات والفقيهات وتم إعادة تفسير أدوارهن لتبدو ثانوية أو داعمة، فاحتكرت السلطة الدينية ومن ثم أصبحت المؤسسات الدينية شبكات لسلطة الرجال، فقامت بإنتاج وتكرار تفسير الدين للحفاظ على هذه السلطة.
ويمكن ملاحظة أن الكتابات الدينية التاريخية التي وصلتنا كانت ذات تركيز ذكوري على الجوانب التشريعية والهيكلية، فهناك ميل لدى الرجال نحو التنظير وكتابة النصوص التشريعية والعقائدية وهي اعمال تنظيرية وهيكلية بامتياز، بينما نجد في التراث الشفهي والممارسات اليومية أنماطًا أخرى من الممارسة الدينية كانت غالبًا من اختصاص النساء اذ هنالك ميل لبعض النساء نحو الممارسة والسياق، فالدين الحي والممارَس في البيت والمجتمع والعلاقات، هو المجال الذي كانت المرأة تخلق فيه تقواهن وتعاليمهن غير المكتوبة.
لكن هناك استثناءات ومساحات، وإن كانت محدودة، ظهرت فيها كتابات ورؤية نسائية لشخصيات قوية كرابعة العدوية التي لم تكتب تشريعًا، لكنها صاغت فلسفة كاملة عن الحب الإلهي خارج منطق السلطة والعقاب، وفاطمة بنت عباس البغدادية الشيخة الصالحة سيدة نساء زمانها التي كانت تصعد المنبر وتعظ النساء، فينيب لوعظها، ويقلع من أساء.
إنّ إصلاح الفهم الديني في عصرنا يتطلب وعيًا بأنّ الوحي شيء، وتفسيره شيء آخر، والتمييز بين الوحي والتفسير يجبرنا على ادراك الفرق بين جوهر الرسالة الدينية المتسامي والعادل وبين التفسير البشري التاريخي الذي يحمل بصمة عصره وثقافته وتحيزاته، وهذا ما سيفتح الباب أمام ضمان مكانة المرأة الكاملة كفاعلة ومفسرة وليس مجرد متلقية لمنظومة تفسيرية جاهزة، فإعادة قراءة التراث وتشجيع مدارس تفسيرية جديدة وربط العلم الديني بالعلوم الإنسانية الحديثة كعلم الاجتماع مهم في هذا الجانب.
وإنّ ما يُسمّى بـالفهم النسائي والفهم الرجالي للدين ليس انعكاسًا لاختلاف بيولوجي، بل نتاج اختلاف في المواقع الاجتماعية وتجارب التنشئة، حيث تُملى على كل جنس أدوار ومعايير تحدد طريقته في إدراك المقدس.
وثمة اتجاه في بعض التفسيرات النسائية المعاصرة تشير الى عادة ما يتشكل فهم الأنثى للدين من خلال السياق والتجسيد والعلاقة بين الأشياء، اذ تميل بعض النساء إلى إدراك الله من خلال شبكة العلاقات، فالله هو المحبة بين الأم وطفلها، وهو التعاطف بين الصديقات، وهو القوة في روابط الأسرة، أي انها تبحث عن الله في الداخل في القلب والحدس والمشاعر وفي العالم المحيط في الطبيعة والمجتمع والمنزل، والمقدس عندها ليس غيبيا منفصلاً عن الحياة اليومية.
وفي السياق الثقافي، نلاحظ أن الله عندها هو "أنت" في لحظة العطاء، وهو "نحن" في لحظة التضامن وتستخدم الدين كمصدر للتمكين والهوية.
كذلك فالدين عندهن ممارسة حياتية ورعاية، وليس منظومة عقائد مجردة فحسب، بل هو الممارسات اليومية التي تمنح الحياة معنى البركة في الطعام، وطقوسها في تنظيف المنزل، والعبادة في تربية الأطفال، والاهتمام بالطقوس التي تشمل الجسد والعواطف.
والقدوة عندهن غالباً ما تكون أنثى كأمهات المؤمنين الذين يمثلن القوة الهادئة والصبر والعطاء غير المحدود.
وهي تنجذب دينيا نحو جوانب الرعاية والعلاج وزيارة المريض ومواساة الحزين ومساعدة المحتاج، أي انها تطلب التدين لحل مشاكل الحياة الواقعية كطلب الشفاء وطلب توفيق الأبناء والبحث عن السلام الداخلي في لحظات الألم.
وفهم بعض النساء للدين غالباً ما يكون عضويًا وشبكيًا، إذ إنّ المقدّس في نسيج الحياة والعلاقات، وليس غيبيا، وعادة ما تختار الانثى ملجأً آمنًا في أماكن مقدسة محددة في داخل العلاقات او في الطبيعة او في الحياة اليومية او في السماء او في النصوص او حتى في السلطة، او في الطقوس المنظمة لتُفضي إليه بهمومها ولتجد فيه القوة، فالله هو المستمع والحامي والمعزي.
هذا البعد للفهم الأنثوي النمطي لطبيعة الله عندهن، فهو القريب والحنون والذي يسمعها من دون الناس، وهو العالي والحاكم والعادل والمشرع.
كذلك فان الهدف من الدين عندهن هو التحول الداخلي والشفاء وبناء المجتمع وإضفاء المعنى على الحياة والطاعة والنظام والعدالة والخلاص الفردي وفهم الكون.
واما المنهج الديني عند اكثر النساء فهو حدسي وعاطفي قائم على الخبرة والتجربة الشخصية، وهو عقلي وتحليلي قائم على النص والقاعدة.
كذلك فان الرمز الديني المفضل عندهن هو الأم والشجرة والماء والكأس والقلب وهي رموز عادة ما تكون حاوية ومحيطة.
ومن الخصائص الأساسية للفهم الأنثوي للدين مقاربة الذنب او الخطيئة يكون كـجرح في العلاقة يحتاج إلى شفاء ومصالحة، مثلما العصيان كخروج عن القانون يحتاج إلى عقاب وتكفير.
وكثير منهن يركزن على ان الله علاقة أكثر من كونه كيانًا منفصلًا، ولذا نراهن يركزن كثيرا على أسماء الله الرحمن الرحيم، وان هناك ربط مقدس بالروابط الإنسانية كالأمومة والرعاية والتراحم، ونظرتها هذه لها ميل لتصور الله من خلال تجارب جسدية وعاطفية ملموسة، ولديهن نوع من الربط بين الروحاني والجسدي معززة بتجربة الحمل والولادة.
وتتمتع بعض النساء بفهم أكثر لسياقية التعاليم الدينية، ورفض للتفسيرات الحرفية الجامدة، مع تركيز على قيم الرحمة والعناية والمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالعدالة الاجتماعية والرحمة والمساواة.
هذا المنظور لله وللدين ليس حكرًا على النساء فحسب، بل هو نمط فهم موجود عند بعض الرجال، لكنه غالبًا ما يكون أكثر بروزًا في التجربة النسائية، فالمنظور الأنثوي يوسع دائرة المقدس ليشمل الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية، معيدًا التوازن للفهم الديني.
بالمقابل فكثير من الرجل عادة ما يتشكل فهمهم لله وللدين بواسطة عدسة الهرمية والهيكلية والقواعد والتجريد، فالله هو المبدأ وهو السلطة، ويميل الرجل إلى إدراك الله كحاكم ومنظم للكون، فبيده القوة المطلقة والعادلة التي تضع الانسان للقانون.
وكثير منهم يبحثون عن الله في الأعلى اذ السماء والعرش وهو المهيب، الجبار، الحكيم.
والدين عندهم كمنظومة وفريضة والإطار الأخلاقي والعقائدي الذي ينظم الحياة، هو عنده مجموعة من القواعد والواجبات والحدود.
والقدوة غالباً ما تكون رجالا كالأنبياء والعلماء والسلف الصالح، وهم يمثلون القوة القيادية والبطولية والتضحية المادية أو المعنوية.
وينجذب اغلب الرجال عادة نحو الجوانب الهيكلية والتنظيمية في الدين كإدارة المساجد ودراسة الفقه والتفسير والقيادة المجتمعية.
اما الروحانية عند اكثرهم فهي رحلة بحث وانضباط اذ يطلب التدين رحلة فكرية وروحية لاكتشاف الحقيقة وفهم أسرار الكون وإثبات الذات عبر التحدي.
اما المسجد فعندهم مكان للعبادة والاجتماع لتنفيذ الفريضة وبناء المجتمع عبر سلالم العقل والانضباط، وأداء الطقوس كختم القرآن او إتمام الصلوات في وقتها فهي أداء وإنجاز، اذ المقدس موجود في قمة نظام منظم، ويتم الوصول إليه عبر الطاعة والانضباط والفهم النظري.
والفهم الديني عند كثير من الرجال يربط الله بالسيادة والنظام، ويميل لتصوير الله كمشرع وحاكم، مع التركيز على الصفات المجردة كالقدرة المطلقة والعلم اللانهائي، ويركز هذا الفهم أيضا على الفروض والطاعة التي غالباً ما تكون على الجانب التشريعي وكيفية الاداء والالتزام بالنصوص والهياكل السلطوية، كما انه يعزز الأدوار التقليدية التي تدعم البنى الأبوية وفي تفسير النصوص لدعم القيادة الذكورية في المجال الديني.
ويمكن تفسير هذا الاختلاف بسبب الأدوار الاجتماعية المختلفة كالرعاية مقابل القيادة، وفي طرق التنشئة كالتعاطف مقابل القوة، فهناك تنوع داخل كل جندر والتجارب الفردية قد تختلف تمامًا عن النمط السائد.
في النهاية، الدين الذي نعرفه اليوم هو نتاج حوار معقد بين الوحي المقدس من جهة، والواقع البشري بكل تناقضاته وتحيزاته من جهة أخرى، والاعتراف بأن الذكور هم من كتبوا وشكلوا هذا التراث ليس هجومًا على الدين نفسه، بل هو اعتراف بواقع تاريخي، وخطوة ضرورية لفهم كيف نصل إلى فهم أكثر توازنًا وعدالة لفهم الدين في عصرنا.
إنّ الوعي الفلسفي المعاصر، مدعوّ إلى إعادة قراءة الدين كخبرة وجودية لا كمنظومة مغلقة، فالله ليس فكرة مجردة، بل علاقة حية بالذات والعالم، فحين تتكامل الرحمة مع العدالة، والعاطفة مع العقل، يتحقق المعنى الأعمق للدين.